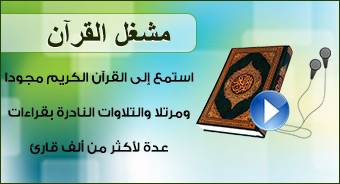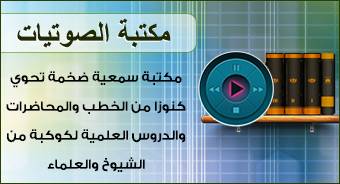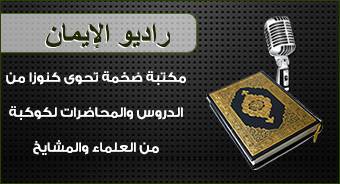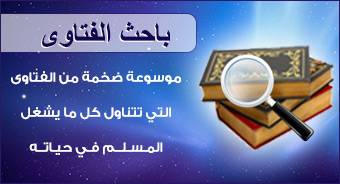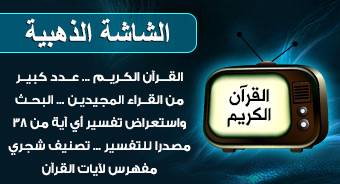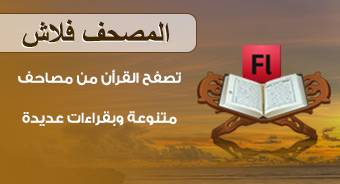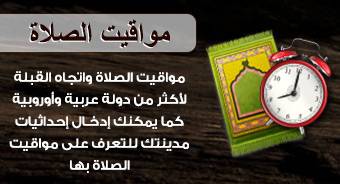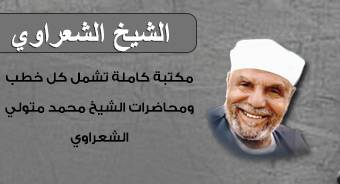.الطرف الثالث في السنين:
.الطرف الثالث في السنين:
وفيه ثلاثة جمل:الجملة الأولى في مدلول السنة والعام:يقال: السنة، والعام، والحول؛ وقد نطق القرآن بالأسماء الثلاثة قال تعالى:
{فلبث فيه ألف سنة إلا خمسين عاماً} فأتى بذكر السنة والعام في آية واحدة، وقال جل وعز:
{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وقد تختص السنة بالجدب والعام بالخصب، وبذلك ورد القرآن الكريم في بعض الآيات قال تعالى:
{ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون} فعبر بالعام عن الخصب وقال جل ذكره:
{ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات} فعبر بالسنين عن الجدب. على أنه قد وقع التعبير بالسنين عن الخصب أيضاً في قوله تعالى:
{قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله} أما الحول فإنه يقع على الخصب والجدب جمعاً.الجملة الثانية في حقيقة السنة:وهي على قسمين: طبيعية واصطلاحية كما تقدم في الشهور:القسم الأول السنة الطبيعية وهي القمرية وأولها استهلال القمر في غرة المحرم، وآخرها سلخ ذي الحجة من تلك السنة، وهي اثنا عشر شهراً هلالياً قال تعالى:
{إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض}. وعدد أيامها ثلثمائة يوم وأربعة وخمسون يوماً وسدس يوم تقريباً، ويجتمع من هذا الخمس والسدس يوم في كل ثلاث سنين فتصير السنة ثلثمائة وخمسة وخمسين يوماً، ويبقى من ذلك بعد اليوم الذي اجتمع شيء، فيجتمع منه ومن خمس اليوم وسدسه في السنة السادسة يوم واحد، وكذلك إلى أن يبقى الكسر أصلاً بأحد عشر يوماً عند تمام ثلاثين سنة، وتسمى تلك السنين كبائس العرب.قال السهيلي: كانوا يؤخرون في كل عام أحد عشر يوماً حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته، فلما كانت سنة حجة الوداع وهي سنة تسع من الهجرة عاد الحج إلى وقته اتفاقاً في ذي الحجة كما وضع أولاً، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحج، ثم قال في خطبته التي خطبها يومئذ:
«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» بمعنى أن الحج قد عاد في ذي الحجة. وفي بعض التعاليق أن سني العرب كانت موافقة لسني الفرس في الدخول الانسلاخ فحدث في أحوالهم انتقالات فسد عليهم بها الكبس في أول السنة السادسة من ملك أغبطش، وذلك بعد ملك ذي القرنين بمائتين وثمانين سنة وأربعين يوماً فسنوا كبس الربع من ذلك اليوم في كل سنة فصارت سنينهم بعد ذلك الوقت محفوظة المواقيت. وقيل لم تزل العرب في جاهليتها على رسم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لا تنسأ سنيها إلى أن جاورتهم اليهود في يثرب، فأرادت العرب أن يكون حجهم في أخصب وقت ن السنة، وأسهل زمان للتردد بالتجارة فعلموا الكبس من اليهود والله أعلم أي ذلك كان.القسم الثاني الاصطلاحية وهي الشمسية وشهورها اثنا عشر شهراً كما في السنة الطبيعية إلا أن كل طائفة راعت عدم دوران سنيها جعلت في أشهرها زيادة في الأيام إما جملة واحدة وإما متفرقة وسمتها نسيئاً بحسب ما اصطلحوا عليه كما ستقف عليه في مصطلح كل قوم إن شاء الله تعالى. وعدد أيامها عند جميع الطوائف من القبط، والفرس، والسريان، والروم، وغيرهم ثلثمائة يوم وخمسة وستون يوماً وربع يوم، فتكون زيادتها على العربية عشرة أيام وثمانية أعشار يوم وخمسة أسداس يوم. وقد قال بعض حذاق المفسرين في قوله تعالى:
{ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعاً} إنه إن حمل على السنين القمرية فهو على ظاهره من العدد، وإن حمل على السنين الشمسية فالتسع الزائدة هي تفاوت زيادة الشمسية على القمرية، لأن في كل ثلثمائة سنة تسع سنين لا تخل بالحساب أصلاً.قال صاحب مناهج الفكر: ولذلك كانوا في صدر الإسلام يسقطون عند رأس كل ثلاث وثلاثين سنة عربية سنة ويسمونها سنة الازدلاف، لأن كل ثلاث وثلاثين سنة عربية اثنتان وثلاثون سنة شمسية تقريباً. قال: وإنما حملهم على ذلك الفرار من اسم النسيء الذي أخبر الله تعالى أنه زيادة في الكفر.ثم المعتبرون السنة الشمسية اختلفت مصطلحاتهم فيها بحسب اختلاف مقاصدهم.المصطلح الأول: مصطلح القبط، وقد اصطلحوا على أن جعلوا شهرهم ثلاثين يوماً كما تقدم، فإذا انقضت الاثنا عشر شهراً أضافوا إليها خمسة أيام يسمونها أيام النسيء، ويفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية، فإذا كانت السنة الرابعة أضافوا إلى خمسة النسيء المذكورة ما اجتمع من الربع يوم الزائد على الخمسة أيام في السنة الشمسية فتصير ستة أيام، ويجعلونها كبيسة في تلك السنة، وبعض ظرفائهم يسمي الخمسة المزيدة السنة الصغيرة.قال أصحاب الزيجات: وأول ابتدائهم ذلك في زمن أغشطش. وكانوا من قبل يتركون الربع إلى أن تجتمع أيام سنة كاملة وذلك في ألف سنة وأربعمائة وإحدى وستين سنة يسقطونها من سنيهم؛ وعلى هذا المصطلح استقر عملهم بالديار المصرية في الإقطاعات، والزرع، والخراج، وما شاكل ذلك.المصطلح الثاني: مصطلح الفرس؛ وشهورهم كشهور القبط في عد الأيام على ما تقدم، فإذا كان آخر شهر أبان ماه، وهو الشهر السابع من شهورهم أضافوا إليه الخمسة الأيام الباقية وجعلوه خمسة وثلاثين يوماً، وتسمي الفرس هذه الأيام الخمسة: الأندركاه؛ ولكل يوم منها عندهم اسم خاص كما في أيام الشهر؛ ولما لم يجز في معتقدهم كبس السنة بيوم واحد بعد ثلاث سنين كما فعل القبط كانوا يؤخرونه إلى أن يتم منه في مائة وعشرين سنة شهر كامل فيلقونه، وتسمى السنة التي يلقى فيها بهبرك، قال المسعودي في مروج الذهب: وإنما أخروا ذلك إلى مائة وعشرين سنة لأن أيامهم كانت سعوداً ونحوساً فكرهوا أ، يكبسوا في كل أربع سنين يوماً فتنتقل بذلك أيام السعود إلى أيام النحوس، ولا يكون النيروز أول يوم من الشهر.وعلى هذا المصطلح كان يجبى الخراج للخلفاء، وتتمشى الأحوال الديوانية في بداية الأمر، وعليه العمل في العراق وبلاد فارس إلى الآن.المصطلح الثالث: مصطلح السريان، وشهورهم على ما تقدم من كونها تارة ثلاثين يوماً وتارة زائدة عيها، وتارة ناقصة عنها، وإنما فعلوا ذلك حتى لا يلحقهم النسيء في شهورهم إذ الأيام الخمسة المذكورة الزائدة على شهور القبط والفرس موزعة على رؤوس الزوائد من شهورهم، وذلك أن من شهورهم سبعة أشهر يزيد كل شهر منا يوماً على الثلاثين وهي تشرين الأول، وكانون الأول، وكانون الثاني، وآذار، وأيار، وتموز، وآب، فتكون الزيادة سبعة أيام يكمل منها شباط وهو ثمانية وعشرون يوماً بيومين يبقى خمسة أيام؛ وهي نظير النسيء في سنة القبط والفرس، ويبقى بعد ذلك الربع يوم الزائد على الخمسة أيام في السنة الشمسية، فإذا انقضت ثلاث سنين مواليات جمعوا الأرباع الثلاثة الملغاة إلى الربع الرابع فيجتمع منا يوم فيجعلونه نظير اليوم الذي كبسه القبط ويضيفونه إلى شباط، فيصير تسعة وعشرين يوماً.المصطلح الرابع: مصطلح اليهود، وشهورهم وإن كانت قمرية كالعربية كما تقدم فقد اضطروا إلى أن تكون سنتهم شمسية لأنهم أمروا في التوراة أن يكون عيد الفطر في زمان الفريك فلم يتأت لهم ذلك حتى جعلوا سنيهم قسمين: الأول بشيطا ومعناه بسيطة وهي القمرية، والثاني معبارت، ومعناه كبيسة وهم يكبسون شهراً كاملاً، ومعبارت اسم موضوع عندهم على الكامل؛ فإنه لما كان في بطنها زيادة عليها كانت هذه السنة مثلها بإضافة الشهر المكبوس إليها، وكل واحدة من السنين ثلاثة أنواع أحدها حسارين ومعناه ناقصة، وهي التي يكون الشهر الثاني والثالث منها وهما مرحشوان وكسلا ناقصين، وكل واحد منهما تسعة وعشرون يوماً؛ والنوع الثاني شلاميم ومعناه تامة، وهي التي يكون فيها كل شهر من الشهرين المذكورين تاماً، والنوع الثالث كسدران معناه معتدلة، وهي التي تكون أشهرها ناقص يتلوه تام؛ وهذا يلزم من جهة أنهم لا يجيزون أن يكون راس سنتهم يوم أحد ول يوم أربعاء ولا يوم خميس.وأما معبارت فإنها تكون فيكل تسع عشرة سنة سبع مرات، ويسمنون الجملة مخزوراً ومعناه الدور؛ وهذه السبعة لا تكون على التوالي، وإنما تكون تارة سنتان بشيطان يتلوهما معبارت، وتارة سنة بشيطا يتلوها معبارت، كل ذلك حتى لا تخرم عليهم قاعدة الثلاثة أيام التي لا يختارونها أن تكون أول سنتهم، فإذ انقضى آذار من هذه السنة كبسوا شهراً وسموه آذار الثاني، فإذا انقضت التسع عشرة سنة أعادوا دوراً ثانياً وعملوا فيه كذلك وعلى هذا أبداً.أما مصطلح المنجمين فالسنة عندهم من حلول الشمس في أول نقطة من رأس الحمل إلى حلولها في آخر نقطة من الحوت، ومنهم من يجعلها من حول الشمس في أول نقطة من رأس الميزان إلى حلولها في آخر نقطة من السنبلة، والأول هو المعروف. وتساهل بعضهم فقال: هي من كون الشمس في نقطة ما من فلك البروج إلى عودها إلى تلك النقطة، ويقال إن سنة الجند والمرتزقة بالديار المصرية كانت أولاً على هذا المصطلح، وبه يعملون في الإقطاعات ونحوها.الجملة الثالثة في فصول السنة الأربعة:وفيه ثلاثة مهايع:المهيع الأول في الحكمة في تغيير الفصول الأربعة في السنة واعلم أن الفصول تختلف بحسب اختلاف طبائع السنة لتباين مصالح أوقاتها حكمة من الله تعالى. قال بطليموس: تحتاج الأبدان إلى تغيير الفصول؛ فالشتاء للتجميد، والصيف للتحليل، والخريف للتدريج، والربيع للتعديل. وعلى ذلك يقال: إن أصل وضع الحمام أربعة بيوت بعضها دون بعض على التدريج ترتيبها على الفصول الأربعة.المهيع الثاني في كيفية انقسام السنة الشمسية إلى الفصول واعلم أن دائرة منطقة البروج لما قاطعت دائرة معدل النهار على نقطتين متقابلتين مال عنهما في جهتي الشمال والجنوب بقدر واحد، فالنقطة التي تجوز عليها الشمس من ناحية الجنوب إلى الشمال عن معدل النهار تسمى نقطة الاعتدال الربيعي، وهي أول الحمل، والنقطة التي تجوز عليها من الشمال إلى الجنوب تسمى نقطة الاعتدال الخريفي وهي أول الميزان. ويتوهم في الفلك دائرة ثالثة معترضة من الشمال إلى الجنوب تمر على أقطاب تقابل الدائرة المخطوطة على الفلكين تقطع كل واحد من فلك معدل النهار وفلك البروج بنصفين، فوجب أن يكون قطعها لفلك البروج على النقطتين اللتين هما في غاية الميل والبعد عن معدل النهار في جهتي الشمال والجنوب فتسمى النقطة الشمالية نقطة المنقلب الصيفي وهي أول السرطان، وتسمى النقطة الجنوبية نقطة المنقلب الشتوي، وهي أول الجدي. واختلاف طبائع الفصول عن حركة الشمس وتنقلها في هذه النقط، فإنها إذا تحركت من الحمل، وهو أول البروج الشمالية أخذ الهواء في السخونة لقربها من سمت الرؤوس وتواتر الإسخان إلى أن تصل إلى أول السرطان، وحينئذ يشتد الحر في السرطان والأسد إلى أن تصل إلى الميزان، فحينئذ يطيب الهواء ويعتدل؛ ثم يأخذ الهواء في البرودة ويتواتر إلى أول الجدي، وحينئذ يشتد البرد في الجدي والدلو لبعد الشمس من سمت الرؤوس إلى أن تصل إلى الحمل فتعود الشمس إلى أو حركتها.المهيع الثالث في ذكر الفصول، وأزمنتها، وطبائعها، وما حصة كل فصل منها من البروج والمنازل؛ وهي أربعة فصول الأول: فصل الربيع: وابتداؤه عند حلول الشمس برأس الحمل، وقد تقدم ومدته أحد وتسعون يوماً وربع يوم ونصف ثمن يوم. وأوله حلول الشمس رأس الحمل، وآخره عند قطعها برج الجوزاء؛ وله من الكواكب القمر، والزهرة، ومن المنازل الشرطان، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع بما في ذلك من التداخل كما مر؛ ومن الساعات الأولى والثانية والثالثة؛ ومن الرياح الجنوب؛ وطبعه حار رطب؛ وله من السن الطفولية والحداثة؛ ومن الاخلاط الدم، ومن القوى الهاضمة. وفيه تتحرك الطبائع، وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيطلع النبات، وتزهر الأشجار وتورق، ويهيج الحيوان للسفاد، وتذوب الثلوج، وتنبع العيون، وتسيل الأودية، وأخذت الأرض زخرفها وازينت فتصير كأنها عروس تبدت لخطابها، في مصبغات ثيابها؛ ويقال: إذا نزلت الشمس رأس الحمل تصرم الشتاء، وتنفس الربيع، واختالت الأرض في وشيها البديع، وتبرجت للنظارة في معرض الحسن والنضارة.ومن كلام الوزير المغربي: لو كان زمن الربيع شخصاً لكان مقبلاً، ولو أن الأيام حيوان لكان لها حلياً ومجللاً، لأن الشمس تخلص فيه من ظلمات حوت السماء، خلاص يونس من ظلمات حوت الماء؛ فإذا وردت الحمل وافت أحب الأوطان إليها وأعز أماكنها عليها.وكان عبدوس الخزاعي يقول: من لم يبتهج بالربيع، ولم سيتمتع بأنواره ولا استروح بنسيم أزهاره، فهو فاسد المزاج، محتاج إلى العلاج.ويروى عن بقراط الحكيم مثله، وفيه بدل قوله: فهو فاسد المزاج، فهو عديم حس، أو سقيم نفس. ولجلالة محل هذا الفصل في القلوب، ولنزوله من النفوس منزلة الكاعب الخلوب، كانت الملوك إذا عدمته استعملت ما يضاهي زهره من البسط المصورة المنقشة، والنمارق المفوقة المرقشة. وقد كان لأنوشروان بساط يسميه بساط الشتاء، مرصع بأزرق الياقوت والجواهر، وأصفره وأبيضه وأحمره، وقد جعل أخضره مكان أغصان الأشجار، وألوانه بموضع الزهر والنوار. ولما أخذ هذا البساط في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في واقعة القادسية، حمل إليه فيما أفاء الله على المسلمين؛ فلما رآه قال: إن أمة أدت هذا إلى أمير لأمينة ثم مزقه فوقع منه لعلي عليه السلام قطعة في قسمه مقدارها شبر في شبر فباعها بخمسة عشر ألف دينار.وقد أطنب الناس في وصف هذا الفصل ومدحه، وأتوا بما يقصر عن شرحه، وتغالى الشعراء فيه غاية التغالي، وفضلوا أيامه ولياليه على الأيام والليالي، وما أحلى قول البحتري:
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً ** من الحسن حتى كاد أن يتكلماوقد نبه النوروز في غسق الدجى ** أوائل ورد كن بالأمس نومايفتحها برد الندى فكأنما ** يبث حديثاً بينهن مكتماومن شجر رد الربيع رداءه ** كما نشرت ثوباً عليه منمنماأحل فأبدى للعيون بشاشة ** وكان قذى للعين إذ كان محرماورق نسيم الجو حتى كأنما ** يجيء بأنفاس الأحبة نعماوأحلى منه قول أحمد بن محمد العلوي:
أو ما ترى الأيام كيف تبرجت ** وربيعها وال عليها قيم؟لبست به الأرض الجمال فحسنها ** متأزر ببروده متعممانظر إلى وشي الرياض كأنه ** وشي تنشره الأكف ينمنموالنور يهوى كالعقود تبددت ** والورد يخجل والأقاحي تبسموالطل ينظم فوقهن لآلئاً ** قد زان منهن الفرادى التوأمويكاد يذري الدمع نرجسها إذا ** أضحى ويقطر من شقائقها الدمومنها:
أرض تباهيها السماء إذا دجا ** ليل ولاحت في دجاها الأنجمفلخضرة الجو اخضرار رياضها ** ولزهره زهر ونور ينجموكما يشق سنا المجرة جره ** واد يشق الأرض طام مفعملم يبق إلا الدهر إذ باهت به ** وحياً يجود به ملث مرهموقول الآخر:
طرق الحياء ببره المشكور ** أهلاً به من زائر ومزوروحبا الرياض غلالة من وشيه ** بغرائب التفويف والتحبيروأعارها حلياً تأنى الغيث في ** ترصيعه بجواهر المنثورومعصفر شرق وأصفر فاقع ** في أخضر كالسندس المنشورفكأن أزرقه بقايا إثمد ** في أعين مكحولة بفتوركملت صفات الزهر فيه فناب عم ** ا غاب من أنواعه بحضوروقول الآخر:
إشرب هنيئاً قد أتاك زمان ** متعطر متهلل نشوانفالأرض وشي والنسيم معنبر ** والماء راح والطيور قيانالثاني: فصل الصيف: وهو أحد وتسعون يوماً وربع ونصف ثمن يوم وابتداؤه إذا حلت الشمس رأس السرطان، وانتهاؤه إذا أتت على آخر درجة من السنبلة؛ فيكون له من البروج السرطان، والأسد، والسنبلة. وهذه البروج تدل على السكون، وله من الكواكب المريخ والشمس؛ ومن المنازل النثرة، والطرف، والجبهة، والزبرة، والصرفة، والعواء، والسماك يتداخل فيه؛ وله من الساعات الرابعة والخامسة والسادسة، ومن الرياح الصبا، وطبعه حار يابس؛ وله من السن الشباب؛ ومن الأخلاط المرة الصفراء؛ ومن القوى القوة النفسية والحيوانية. وللعرب في هذا الفصل وغرات: وهي الحرور؛ منها وغرة الشعرى، ووغرة الجوزاء، ووغرة سهيل، أولها أقواها حراً؛ يقال إن الرجل في هذه الوغرة يعطش بين الحوض والبئر، وإذا طلع سهيل ذهبت الوغرات؛ وتسمى الرياح التي في هذه الوغرات البوارح؛ سميت بذلك لأنها تأتي من يسار الكعبة كما برح الظبي إذا أتاك من يسارك؛ وقد أولع الناس بين لفحات الحر وسمومه، وأتوا فيه ببدائع تقلع الصب غمام عمومه. وفي ذلك قول بعضهم: أوقدت الظهيرة نارها، وأدكت أوارها، فأذابت دماغ الضب، وألهبت قلب الصب؛ وهاجرة كأنها من قلوب العشاق، إذا اشتعلت فيها نار الفراق، حر تهرب له الحرباء من الشمس، وتستجير بمتراكم الرمس؛ لا يطيب معه عيش، ولا ينفع معه ثلج ولا خيش؛ فهو كالقلب المهجور، أو كالتنور المسجور. ووصف بعضهم، وهو ذو الرمة، حر هاجرة فقال:
وهاجرة حرها واقد ** نصبت لحاجبها حاجبيتلوذ من الشمس أطلأوها ** لياذ الغريممن الطالبوتسجد للشمس حرباؤها ** كما يسجد القس للراهبوقال سوار بن المضرس:
وهاجرة تشتوى بالسموم ** جنادبها في رؤوس الأكمإذا الموت أخطأ حرباءها ** رمى نفسه بالعمى والصمموقال أبو العلاء المعري:
وهجيرة كالهجر موج سرابها ** كالبحر ليس لمائها من طحلبواخى به الحرباء عودي منبر ** للظهر إلا أنه لم يخطبوقال آخر:
ورب يوم حره منضج ** كأنه أحشاء ظمآنكأنما الأرض على رضفة ** والجو محشو بنيرانوبالغ الأمير ناصر بن الفقيسي فقال من أبيات:
في زمان يشوى الوجوه بحر ** ويذيب الجسوم لو كن صخرالا تطير النسور فيه إذا ما ** وقفت شمسه وقارب ظهراويود الغصن الرطيب به لو ** أنه من لحائه يتعرىوقال أيضاً يصف ليلة شديدة الحر:
يا ليلة بث بها ساهراً ** من شدة الحر وفرط الأواركأنني في جنحها محرم ** لو أن للعورة مني استتاروكيف لا أحرم في ليلة ** سماؤها بالشهب ترمي الجمارعلى أن أبا علي بن رشيق قد فضله على فصل الشتاء فقال:
فصل الشتاء مبين لا خفاء به ** والصيف أفضل منه حين يغشاكافيه الذي وعد الله العباد به ** في جنة الخلد إن جاؤوه نساكاأنهار خمر وأطيار وفاكهة ** ما شئت من ذا ومن هذا ومن ذاكافقل لمن قال لولا ذاك لم يك ذا ** إذا تفضل على أخراك دنياكاسم الشتاء بعباس تصب غرضاً ** من الصواب وسم الصيف ضحاكاالثالث: الخريف: وهو أحد وتسعون يوماً وربع يوم ونصف وثمن يوم، وأوله عند حلول الشمس رأس الميزان؛ وذلك في الثامن عشر من توت وإذا بقي من أيلول ثمانية أيام؛ وآخره إذا أتت الشمس على آخر درجة من القوس؛ فيكون له من البروج الميزان والعقرب والقوس؛ وهذه البروج تدل على الحركة، وله من الكواكب زحل، ومن الساعات السابعة والثامنة. والطالع فيه مع الفجر من المنازل الغفر والزبانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة يتداخل فيه. وهو بارد يابس، له من السن الكهولة؛ تهيج فيه المرة السوداء، وتقوى فيه القوة الماسكة، وتهب فيه الرياح الشمالية، وفيه يبرد الهواء، ويتغير الزمان، وتنصرم الثمار، ويتغير وجه الأرض، وتهزل البهائم، وتموت الهوام، وتجحر الحشرات، ويطلب الطير المواضع الدفئة، وتصير الأرض كأنها كهلة مدبرة. ويقال: فصل الخريف ربيع النفس كما أن الربيع ربيع العين، فإنه ميقات الأقوات، وموسم الثمار، وأوان شباب الأشجار؛ وللنفوس في آثاره مربع، وللجسوم بمواقع خيراته مستمتع. وقد وصفه الصابي فقال: الخريف أصح فصول السنة زماناً، وأسهلها أوانا؛ وهو أحد الاعتدالين المتوسطين بين الانقلابين، حين أبدت الأرض عن ثمرتها، وصرحت عن زبدتها؛ وأطلقت السماء حوافل أنوائها، وآذنت بانسكاب مائها؛ وصارت الموارد، كمتون المبارد؛ صفاء من كدرها، وتهذباً من عكرها؛ واطراداً مع نفحات الهواء، وحركات الرياح الشجواء؛ واكتست الماشية وبرها القشيب، والطائر رشه العجيب.ومن كلام ابن شبل: كل ما يظهر في الربيع نواره ففي الخريف تجتنى ثماره.وقال أبو بكر الصنوبري:
ما قضى في الربيع حق المسرا ** ت مضيع لحقها في الخريفنحن منه على تلقي شتاء ** يوجب القصف أو وداع مصيففي قميص من الزمان رقيق ** وراداء من الهواء خفيفيرعد الماء فيه خوفاً إذا ما ** لمسته يد النسيم الضعيفوقال ابن الرومي يصفه:
لولا فواكه أيلول إذا اجتمعت ** من كل فن ورق الجو والماءإذاً لما حفلت نفسي إذا اشتملت ** علي هائلة الحالين غبراءيا حبذا ليل أيلول إذا بردت ** فيه مضاجعنا والريح شجواءوخمش القر فيه الجلد والتأمت ** من الضجيعين أجسام وأحشاءوأسفر القمر الساري بصفحته ** يرى لهها في صفاء الماء لألاءبل حبذا نفحة من ريحه سحراً ** يأتيك فيها من الريحان أنباءقل فيه ما شئت من فضل تعهده ** في كل يوم يد لله بيضاءوقال عبد الله بن المعتز يصفه يفضله على الصيف من أبيات:
طاب شرب الصبوح في أيلول ** برد الظل في الضحى والأصيلوخبت لفحة الهواجر عنا ** واسترحنا من النهار الطويلوخرجنا من السموم إلى بر ** د نسيم وطيب ظل ظليلفكأنا تزداد قرباً من الجن ** ة في كل شارق وأصيلووجوه البقاع تنتظر الغي ** ث انتظار المحب رد الرسولوقريب منه قول الآخر:
اشرب على طيب الزمان فقد حدا ** بالصيف للندمان أطيب حادوأشمنا بالليل برد نسيمه ** فارتاحت الأرواح في الأجسادوافاك بالأنداء قدام الحيا ** فالأرض للأمطار في استعدادكم في ضمائر تربها من روضة ** بمسيل ماء أو قرارة وادتبدو إذا جاء السحاب بقطره ** فكأنما كنا على ميعادومما يقرب منه قول جحظة البرمكي:
لا تصغ للوم إن اللوم تضليل ** واشرب ففي الشرب للأحزان تحليلفقد مضى القيظ واجتثت رواحله ** وطابت الريح لما آل أيلولوليس في الأرض بيت يشتكي مرهاً ** إلا وناظره بالطل مكحولوبالغ بعضهم فسوى بينه وبين فصل الربيع فقال في ضمن تهنئة لبعض إخوانه:
هنيت إقبال الخري ** ف وفزت بالوجه الوضيتم اعتدالاً في الكما ** ل فجاء في خلق سويفحكى الربيع بحسنه ** ونسيم رياه الذكيوينوب ورد الزعفرا ** ن له عن الورد الجنيوأبلغ منه قول الآخر يفضله على فصل الربيع الذي هو سيد الفصول ورئيسها:
محاسن للخريف لهن فخر ** على زمن الربيع وأي فخربه صار الزمان أمام برد ** يراقب نزحه وعقيب حرومع ذلك فالأطباء تذمه لاستيلاء المرة السوداء فيه، ويقولون: أن هواءه رديء متى تشبث بالجسم لا يمكن تلافيه؛ وفي ذلك يقول بعض الشعراء:
خذ في التدثر في الخريف فإنه ** مستوبل ونسيمه خطافيجري مع الأيام جري نفاقها ** لصديقها ومن الصديق يخافالرابع: فصل الشتاء: وهو أحد وتسعون يوماً وربع يوم ونصف ثمن يوم، ودخوله عند حلول الشمس رأس الجدي؛ وذلك في الثامن عشر من كيهك وإذا بقي من كانون الأول ثمانية أيام؛ وآخره إذا أتت الشمس على آخر درجة من الحوت فيكون له من البروج الجدي والدلو والحوت؛ وهذه البروج تدل على السكون؛ والطالع فيه مع الفجر سعد الذابح، وسعد بلغ، وسعد السعود، وسعد الأخبية، والفرغ المقدم والفرغ المؤخر، والرشاء. فيه تهب رياح الدبور؛ وهو بارد رطب. فيه يهيج البلغم، وتضعف قوى الأبدان. له من السن الشيخوخة، ومن القوى البدنية القوة الدافعة، وفيه يشتد البرد، ويخشن الهواء، ويتساقط ورق الشجر، وتنجحر الحيات، وتكثر الأنواء، ويظلم الجو، وتصير الأرض كأنها عجوز هرمة قد دنا منها الموت. وله من الكواكب المشتري وعطارد، ومن الساعات العاشرة والحادية عشرة. ويقال: إذا حلت الشمس الجدي، مد الشتاء رواقه، وحل بطاقه، ودبت عقارب البرد لاسبة، ونفع مدخر الكسب كاسبه. وللبلغاء وصف حال من أظله ملح تدفع عن المقرور متى استعد بها طله ووبله.فمن ذلك قول بعضهم يصف شدة البرد: برد يغير الألوان، وينشف الأبدان، ويجمد الريق في الأشداق، والدمع في الآماق؛ برد حال بين الكلب وهريره، والأسد وزئيره، والطير وصفيره، والماء وخريره.ومن كلام الفاضل: في ليلة جمد خمرها، وخمد جمرها، إلى يوم تود البصلة لو ازدادت قمصاً إلى قمصها، والشمس لو جرت النار إلى قرصها؛ أخذه بعضهم فقال:
ويومنا أرياحه قرة ** تخمش الأبدان من قرصهايومن تود الشمس من برده ** لو جرت النار إلى قرصهاولابن حكينا البغدادي:
البس إذا قدم الشتاء برودا ** وافرش على رغم الحصير لبوداالريق في اللهوات أصبح جامداً ** والدمع في الآماق صار بروداوإذا رميت بفضل كأسك في الهوا ** عادت إليك من العقيق عقوداوترى على برد المياه طيورها ** تختار حر النار والسفودايا صاحب العودين لا تهملهما ** حرق لنا عوداً وحرك عوداولبعضهم:
شتاء تقلص الأشداق منه ** وبرد يجعل الشبان شبيباوأرض تزلق الأقدام فيها ** فما تمشي بها إلا دبيباومن كلام الزمخشري:
أقبلت يا برد ببرد أجود ** تفعل بالأوجه فعل المبردأظل في البيت كمثل المقعد ** منقبضاً تحت الكساء الأسودلو قيل لي أنت أمير البلد ** فهات للبيعة كفاً يعقدومن كلام أبي عبد الله بن أبي الخصال يصف ليلة باردة من رسالة: والكلب قد صافح خيشومه ذنبه، وأنكر البيت وطنبه، والتوى التواء الجباب، واستدار استدارة الحباب، وجلده الجليد، وضربه الضريب، وصعد أنفاسه الصعيد، فحماه مباح، ولا هرير ولا نباح.ومن شعر الحماسة في وصف ليلة شديدة البرد:
في ليلة من جمادى ذات أندية ** لا يبصر الكلب من أندائها الطنبالا ينبح الكلب فيها غير واحدة ** حتى يلف على خيشومه الذنباولأبي القاسم التنوخي:
وليلة ترك البرد البلاد بها ** كالقلب أسعر ناراً فهو مثلوجفإن بسطت يداً لم تنبسط خصراً ** وإن تقل فبقول فيه تثبيجفنحن منه ولم تخرس ذوو خرس ** ونحن فيه ولم نفلج مفاليجوقال بعضهم يصف يوماً بارداً كثير الضباب:
يوم من الزمهرير مقرور ** عليه جيب السحاب مزروروشمسه حرة مخدرة ** ليس لها م ضبابه نوركأنما الجو حشوه إبر ** والأرض من تحته قواريروحكي أن أعرابياً اشتد به البر فأضاءت نار فدنا منها ليصطلي، وهو يقول: اللهم لا تحرمنيها في الدنيا ولا في الآخرة؛ آخذه بعضهم فقال وهو في غاية المبالغة:
أيا رب إن البرد أصبح كالحاً ** وأنت بحالي عالم لا تعلمفإن كنت يوماً مدخلي في جهنم ** ففي مثل هذا اليوم طابت جهنموقد اعتنى الناس بمدحه فقال بعضهم: لو لم يكن من فضله إلا أنه تغيب فيه الهوام وتنجحر الحشرات، ويموت الذباب، ويهلك البعوض، ويبرد الماء، ويسخن الجوف، ويطيب العناق، ويظهر الفرش، ويكثر الدخن، وتلذ جمرة البيت لكفى.وتابعه بعض الشعراء فقال:
تركت مقدمة الخريف حميده ** وبدا الشتاء جديده لا ينكرمطر يروق الصحو منه وبعده ** صحو يكاد من الغضارة يمطرغيثان والأنواء غيث ظاهر ** لك وجهه والصحو غيث مضمرأذن الشتاء بلهوه المستقبل ** فدنت أوائله بغيث مسبلمتكاثف الأنواء منغدق الحيا ** هطل الندى هزج الرعود بجلجلجاءت بعزل الجدب فيه فبشرت ** بالخصب أنواء السماك الأعزلوقد ولع الناس بذكر الاعتدال لها قديماً وحديثاً.قيل لأعرابي: ما أعددت للبر؟ فقال: طول الرعدة، وتقرفص العقدة، وذوب المعدة، أخذه ابن سكرة، فقال:
قيل ما أعددت للبر ** د وقد جاء بشدهقلت دراعة عري ** تحتها جبة رعدةواعلم أن ما تقدم من أزمان الفصول الأربعة هو المصطلح المعروف، والطريق المشهور. وقد ذكر الآبي في كتاب الدر: أن العرب قسمت السنة أربعة أجزاء فجعلواالجزء الأول الصفرية وسموا مطره الوسمي، وأوله عندهم سقوط عرقوة الدلو السفلى، وآخره سقوط الهقعة، وجعلوا الجزء الثاني الشتاء، وأوله سقوط الهنعة، وآخره سقوط الصرفة. وجعلوا الجزء الثالث الصيف، وأوله سقوط العواء، وآخره سقوط الشولة، وجعلوا الجزء الرابع القيظ. وسموا مطره الخريف، وأوله سقوط النعائم، وآخره سقوط عرقوة الدلو العليا.وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب طريقاً آخر فقال: الربيع يذهب الناس إلى أنه الفصل الذي يتبع الشتاء ويأتي فيه الورد والكمأة، والنور، ولا يعرفون الربيع غيره، والعرب تختلف في ذلك فمنهم من يجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه الثمار، وهو الخريف، وبعده فصل الشتاء، ثم فصل الصيف وهو الوقت الذي تسميه العامة الربيع، ثم فصل القيظ وهو الذي تسميه العامة الصيف، ومنهم من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع الأول، ويسمي الفصل الذي يلي الشتاء وتأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني؛ وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع.وفي بعض التعاليق أن من العرب من جعل السنة ستة أزمنة: الأول الوسمي وحصته من السنة شهران، ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة وهي العواء، والسماك والغفر، والزبان، وثلثا الإكليل. الثاني الشتاء، وحصته من السنة شهران، ومن المنازل أربع منازل وهي ثلث الكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وثلث الذابح، الثالث الربيع، وحصته من السنة شرهان، ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة، وهي ثلثا الذابح وبلع، والسعود، والأخبية، والفرغ المقدم، الرابع الصيف، وحصته من السنة شهران، ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة، وهي الفرغ المؤخر، وبطن الحوت، والشرطان، والبطين، وثلثا الثريا، والخامس الحميم، وحصته من السنة شهرا، ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة وهي ثلث الثريا، والدبران والهقعة، والهنعة، والذراع وثلث النثرة، السادس الخريف، وحصته من السنة شهران، ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة وهي ثلثا الثنرة، والطرف، والجبهة، والخرتان، والصرفة.والأوائل من علماء الطب يقسمون السنة إلى الفصول الأربعة، إلا أنهم يجعلون الشتاء والصيف أطول زماناً وأزيد مدة من الربيع والخريف، فيجعلون الشتاء أربعة أشهر، والصيف أربعة أشهر، والربيع شهرين، والخريف شهرين، إذ كانا متوسطين بين الحر والبرد وليس في مدتهما طول ولا في زمانهما اتساع.واعلم أن ما تقدم من تفضيل بعض الفصول على بعض إنما هو أقاويل الشعراء وأفانين الأدباء، تفنناً في البلاغة؛ وإلا فالواضع حكيم جعل هذه الفصول مشتملة على الحر تارة وعلى البرد أخرى لمصالح العباد، ورتبها ترتيباً خاصاً على التدريج، يفهم ذلك أهل العقول وأرباب الحكمة، جلت صنعته أن تكون عرية عن الحكمة، أو موضوعة في غير موضعها
{ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير}.